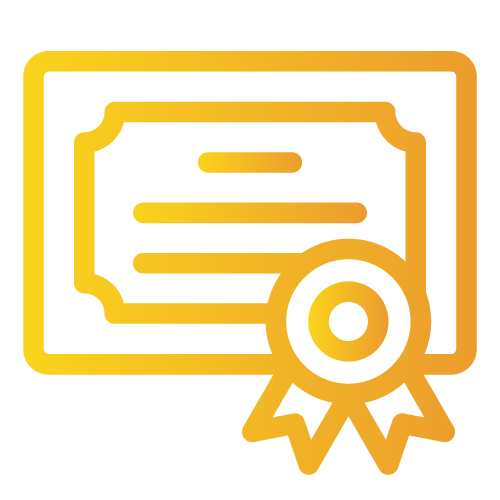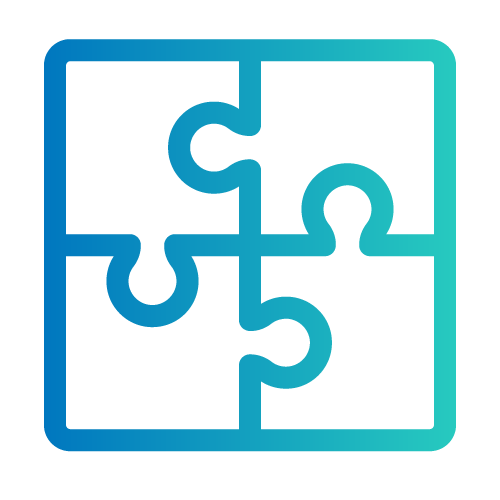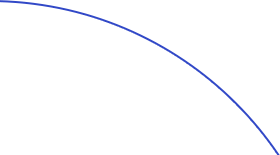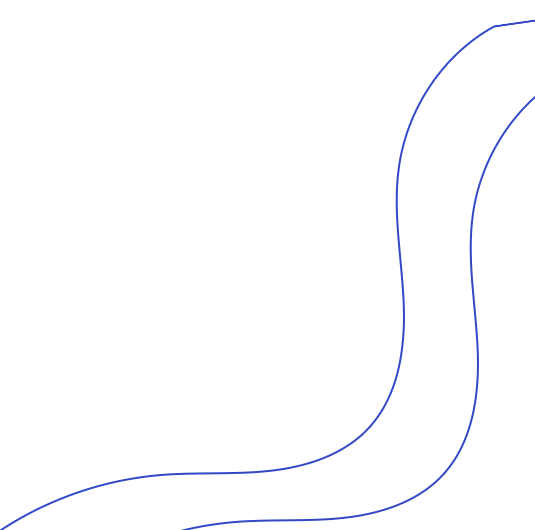حتى يغيروا ما بأنفسهم
المقصود آية: "إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم" (الرعد: 11)
في العالم الإسلامي العديد من الشباب عنده استعداد أن يبذل روحه وماله في سبيل الإسلام، ولكن قلّ من هو مستعدّ أن يبذل سنين يقضيها في دراسة جادّة ليبحث مثلاً مشكلة الانفصال الذي يعيشه المسلم بين سلوكه وعقيدته. مع أن هذا السؤال وكثير من الأسئلة لا بدّ من الإجابة عليها حتى يحصل التغيير، ولا يمكن حصول الأجوبة بدون دراسة جادة. لقد بقي العالم الإسلامي حتى الآن لا يثق بقيمة الدراسة الجادة للمشكلات حتى نخرج بحلول لها.
نحن نتشوق كثيراً إلى التغيير، ولكن لا ندرك أن مردّ مشكلتنا إلى ما بالنفس، أننا نحن المسؤولون، وهذا ما يعلمنا إياه القرآن ويعلمنا إياه التاريخ. من أول الخطوات المطلوبة أن ننظر إلى مشكلاتنا أنها خاضعة للقوانين، أو السنن بلغة القرآن، وبالتالي فهي قابلة للحل، ولا نعني طبعاً أنّ كلّ المسلمين إما يؤمن بالتغيير المقصود تماماً أو لا يؤمن به، بل هناك درجات بين هذا وذاك.
فهنا للموضوع وجهان: أن نؤمن بأنّ مشكلتنا لها حلّ، وثانياً أن الحل يأتي من طريق فهم القوانين اللازمة واستخدامها للحل، فالله جعل القوانين جاهزة لطاعة الإنسان "وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض" (الجاثية: 13) على شرط أن يفهمها.
مشكلات النفس والثقافة أصعب من مشكلات الجسد
صحيح أن الناس ساروا كثيراً في التعامل مع مشكلات الجسد وأمراضه على أن لها قوانين قابلة لدراستها وتسخيرها، ولكننا لم نسر كثيراً في التعامل مع مشكلات مجتمعنا على أن له قوانين بقوة قوانين الجسد، قابلة للدراسة والتسخير. لهذا يكتفي المسلمون بنسبة أمور أحوال الأمة إلى القضاء والقدر، مع أنّ القضاء والقدر نافذ سواء عرفنا القوانين أم لم نعرفها، فلا يمنعنا القضاء والقدر مع التعامل مع الأحداث والأوضاع النفسية والاجتماعية والثقافية بقدرة وفعالية كما حدث في أمور كثيرة وفي أمور أمراض الأجساد.
فحينما نرى في المجتمع التدابر والعجز عن القيام بالواجبات الاجتماعية المشتركة، وهروب الكبار من حمل مسؤولية سلوكهم، فهذه علل أو أمراض قابلة للدراسة والسبر والمعالجة. فحينما ندرك هذه القاعدة الأساسيّة يصبح عملنا منهجياً مضبوطاً، مثلما ترى الطبيب يدرس تحاليل مختلفة وفحوصاً محددة ليكشف المرض ويصل إلى العلاج. فهكذا في أمراض المجتمع وعلله.
تشابه أوصاف الثقافة والمجتمع مع أوصاف الأجسام
تشابه علل الثقافة والمجتمع وعلل الأجسام نبه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث مثل: "ترى المسلمين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضواً تداعى له سائر جسده بالسهر والحمّى" (البخاري) وهذا التشبيه بين أحوال الأمم وأحوال الفرد موجود في القرآن: "لكلّ أمة أجل"، شبه حياة الأمة بحياة الفرد. ولدينا تشبيهات مشهورة أخرى في الحديث الشريف، تقرّب إلينا أوضاع الأمة من خلال أمثلة ملموسة، مثل تشبيه المؤمن للمؤمن كالبنيان، وقصة السفينة والخرق. دراسة مثل هذه الأمور، وإدراك خضوع أحوال الأمم والمجتمعات لقوانين مضبوطة هو العلم المهمّ الذي يحتاجه المسلمون حتى يتقدموا بنجاح في تغيير أوضاع أمتهم. يسهل علينا فهم الخرق في السفينة وما يحدث لها بسبب الخرق، ولكن كم نحتاج من العلم لنفهم الخرق الذي يحدث للمجتمع!
قد نشعر بالراحة ونحن نرمي مشكلات المجتمع على القضاء والقدر، ولكن هذه الراحة تؤدّي إلى صعوبات تضاف إلى صعوبات في تقدمنا وسيرنا. فلا بد من علم يربط بين الهدف والوسيلة وطاقة الإنسان. لدينا أهدافنا، والله أعطانا طاقة، والعلم يفهمنا الوسيلة إلى تحقيق أهدافنا، فهنا علينا صبّ الجهود. لا أن نهمل سنن الله ونتمنّى التغيير. وهنا فائدة الآية الكريمة: "إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم" (الرعد: 11).
الآية تتحدث عن سنة للبشر وليست خاصة بالمسلمين
نحتاج لبضع ملاحظات حول الآية: أنّ السنن التي نتحدث عنها هنا عامة للبشر، لا خاصّة بالمسلمين، فهكذا قانون الله تعالى، ينطبق على أبناء كل عرق ودين، وإن كان المسلمون يميلون إلى الاعتقاد أنّ لهم خصوصيّة. وطبعاً حينما يظنّ المسلمون أنّ النظام الذي ينطبق على كلّ البشر لا ينطبق عليهم فلن يسارعوا إلى دراسة التاريخ، ولكن الرسول صلّى الله عليه وسلّم ينبهنا: "لتتبّعن سنن من قبلكم"، فالمسلمون ترتفع أحوالهم وتنخفض بحسب ما في أنفسهم، وهذا ينطبق على غيرهم وينطبق عليهم.
كما نفهم من الآية أنّ مشكلتنا مشكلة قوم وجماعة، مشكلة إنسانيّة، لا مشكلة عقيدة ودين، وإن كان الدين سيبقى أعزّ ما في أيدينا. فعلينا من جانب الحرص على الدين، ولكن علينا في نفس الوقت علينا التخلّص من الظنون الخاطئة والأوهام، التي يعطيها بعض المسلمين قداسة مثل قداسة القرآن.
فلا بدّ إذن من معرفة أمور ثلاثة:
- معرفة سنن التغيير لما في الأنفس
- معرفة ما ينبغي أن نغيره من أوهام، وما ينبغي أن نحافظ عليه من حقائق
- معرفة من هؤلاء الذين ينبغي أن نجري التغيير على ما في أنفسهم.
كل هذا ضروري لأيّ عملٍ جادّ في التغيير.
نحتاج أيضاً أن نلاحظ في الآية أنّ السنة التي تتحدث عنها مشكلة مجتمع لا مشكلة فرد، تقول الآية "ما بقوم" فهي تتحدث عن مجموعة، عن قوم، عن أمة، لا عن فرد.
كما إنّ الآية تتحدث عن أوضاع القوم أي المجتمع أو الأمة في حياتهم الدنيا، أما يوم القيامة فالحساب فردي، كل شخص يحاسب عن نفسه لا عن غيره "ألا تزر وازرة وزر أخرى" (النجم: 38) "ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً" (مريم: 80)، فهذا واضح، وانطباق سنن المجتمع على المجتمع واضح أيضاً، كما في آية: "واتقوا فتنة لا تصيبنّ الذين ظلموا منكم خاصّة" (الأنفال: 25)
تغيير ما بالنفوس أولاً
وأيضاً حينما نتأمّل في هذه الآية فلننتبه إلى أنّ الله تعالى جعل تغيير الناس لما في أنفسهم قبل تغييره لأحوالهم، فمهما تمنّى الناس وحلموا بالتغيير فلا بدّ من تقديمهم التغيير المطلوب منهم أولاً، فحوادث التاريخ لا تنفصل عن أوضاع النفوس، يحدث تغيير في النفوس فيحدث تغيير في الأوضاع والحظوظ، وواجبنا في تغيير ما بالنفوس.
لكن حينما تتغيّر أحوال أمة ما، مثل الانتقال من الفقر إلى الغنى، فلا يعني هذا أنّه لا يبقى فقير، لأنّ هذا القانون ينطبق على الأمة أو القوم عموماً، ولا يعني عدم وجود الفقراء. وكذلك أحوال الصحة والسقم، فأنت ترى أمة ترتفع فيها الصحة الطيبة إلى نسبة أعلى من غيرها، ولا يعني هذا اختفاء المرض. وهكذا في أمور العزة والذلة، تصبح الأمة عزيزة أو منهزمة بحسب أحوال النفوس.
ماذا نغيّر؟
ويتساءل الإنسان ماذا يطلب منا أن نغير في النفوس؟ والمراد بما في الأنفس واسع: يشمل الأفكار والمفاهيم والظنون، ويشمل عالم الشعور وعالم اللاشعور. وربّما يكون هذا ما قصده العبقري ابن خلدون من وجود ظاهر التاريخ وباطن التاريخ.
أما ما يحدثه الله تعالى من تغيير يتوازى مع تغيير ما بالأنفس، فهو يشمل أموراً كثيرة، مثل الغنى والفقر، الصحة والسقم، العزة والذلة، الفعالية والفشل، وهكذا.
فحينما لا يدرك الشباب هذه القواعد في التغيير، فهم يصابون بالإحباط، وربّما لجأوا إلى أساليب عنيفة تحطم بدل أن تبني.
الله لا يخلف وعده، فحينما يغير قوم ما أي تغيير في أنفسهم، من الصواب إلى الخطأ أو من الخطأ إلى الصواب، فإنّ الله يغيّر أحوالهم بحسب ذلك. من الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى. وقد أوضح القرآن الكريم إمكانية العمل على تغيير ما بالنفس: "قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسّاها" (الشمس: 10) فهنا نسبَ ربّنا التزكية والتدسية للعبد، فالإنسان يولد ميالاً إلى الحق، وهذه هي الفطرة، لا أنّه يولد مسلماً جاهزاً، وما يحدث من مؤثرات البيئة لا يبقي الفطرة على صفائها، كما قال ابن تيمية: "قد يعرض للفطرة ما يفسدها ويمرضها فيرى الحقّ باطلاً". نحتاج إذن إلى جهد حتى نعيد الفطرة إلى صوابها، ولا يكفي تغيير فرد أو أفراد، بل لا بدّ أن تصبح المفاهيم والأفكار والمعارف اللازمة للتغيير سائدة إلى حدّ كاف لتغيير النسبة العامة في المجتمع، ويتغيّر بالتالي واقعهم إلى حدّ يتناسب مع تغيّر الداخل.
كيف نفهم ارتفاع الناس وانخفاضهم؟
كيف نفهم تغيرات البشر من الأدنى إلى الأعلى أو بالعكس؟ أين نتوجّه من أجل الفهم؟ القرآن الكريم يوجهنا أن نبحث في أحوال العالم بالتحرك والدراسة في أرجاء الدنيا والماضي والحاضر: "قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق." (العنكبوت: 20). ونفهم من خلال مراقبة ما حدث في التاريخ والعالم كيف تغيرت مفاهيم الناس فتغيرت أحوالهم الملموسة. وربّما نلاحظ من خلال هذه الحقائق كم أعطى الله للإنسان من دور في صنع التاريخ، فالله جعل تغيير الناس لما في أنفسهم سابقاً لما يحدث لديهم من تغيير، تغيير نحو الأفضل أو نحو الأسوأ. وقيمة ما في يد البشر هائل، لذلك نجد في آية أخرى: "ولقد مكّناكم في الأرض" (الأعراف: 10). وإذا لم ننتبه إلى حصول التغييرين، أي تغيير شيء مما في النفوس، عن قصد أو غير قصد، وتغيير الأحوال المادية والمعنوية، فلا نلاحظ عدل الله تعالى ورحمته. فحينما ترى في القرآن الكريم أن الله نصر قوماً أو خذلهم، فلا يجوز أن نرتاب في مسؤولية الناس عن ذلك، فالله عادل ورحيم في كلّ الأحوال. لذلك حينما حصل ما حصل في غزوة أحد نبه الله الصحابة إلى أنّهم لا يحقّ لهم أن ينسوا مسؤوليتهم عن ذلك: "قل هو من عند أنفسكم" (آل عمران: 165). وحينما نرى في القرآن الكريم أنّ الله أزاغ قلوب قومٍ ما أو أضلّهم، فعلينا أن نلاحظ آيات أخرى توضّح أنّ هذا لا يخرج عن عدل الله ورحمته، لأنّ الله لم يضلّهم إلا بسبب خطوات من طرفهم: "فلمّا زاغوا أزاغ الله قلوبهم" (الصف: 5). فسنن الله وقوانينه متينة ثابتة تنطبق على الجميع.
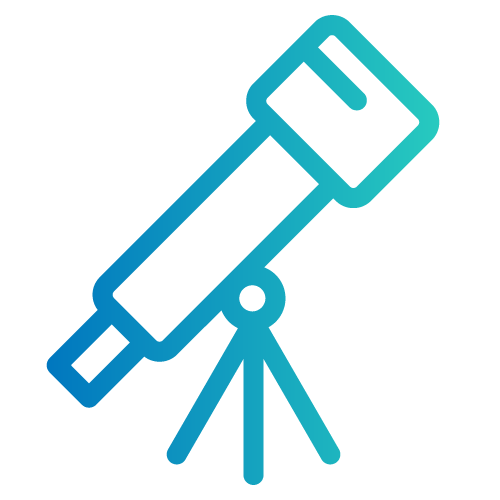
تصنيفات الإضاءات العلمية
النشرة البريدية
يمكنك متابعة أهم الدورات من خلال النشرات البريدية